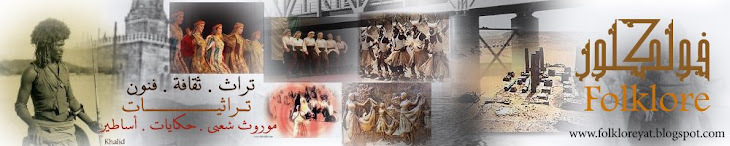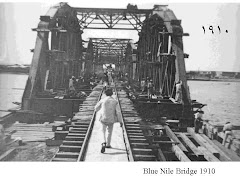التدخل الجراحي حل وحيد لعلاج انحراف الوتيرة الأنفية
د. مجدي عبد الكريم - استشاري الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف : عمّان -
يشكو العديد من الناس من انحراف الوتيرة الانفية ومشاكلها، ولا ننسى ان حوالي 80% من الناس لديهم هذا الانحراف، فما هي تداعياته وعلاجه؟
- الحاجز الانفي عبارة عن جدار يفصل الأنف الى فتحتين متساويتين تقريبا. يتكون من جزء غضروفي أمامي وجزء عظمي خلفي وهو مبطن بغشاء رقيق.
- يكون الحاجز الانفي منذ الولادة وخلال فترة الطفولة في المنتصف، لكنه ينحرف مع النمو الى احدى الجهات دون سبب واضح.
وفي فترة المراهقة فإن التعرض الى ضربات على الانف مسببة انحراف الحاجز يعتبر من اهم الاسباب.
- عند انحراف الحاجز الى احدى الجهتين فإنه يسبب اغلاقا لمجرى التنفس في تلك الجهة.
الأعراض والمضاعفات:
اعوجاج الحاجز الأنفي يسبب العديد من المضاعفات بسبب انسداد مجرى التنفس وعدم دخول الهواء وترطيب الأغشية الأنفية منها:
أ- صداع مزمن.
ب- انسداد مزمن في الانف.
ج- شخير. د- التهاب مزمن في الجيوب الأنفية.
هـ - التهابات متكررة في الأذن الوسطى بسبب اغلاق قناة استاكيوس، التي تصل بين الأذن والانف.
و- التهابات الحلق المتكررة. ح- تشوه منظر الأنف الخارجي وانحرافه باتجاه انحراف الحاجز، والقاعدة تقول "أينما يتجه الحاجز الأنفي يتجه المظهر الخارجي للأنف ولا يصلح المظهر الخارجي الا بعد تعديل الحاجز".
ط - النزيف الأنفي بسبب جفاف الاغشية الانفية وعدم ترطيب الهواء.
ي- انسداد الانف من الجهة المقابلة للانحراف بسبب تضخم القرنيات في الجهة الاخرى لوجود فراغ كبير في الفتحة الانفية المقابلة للانحراف.
التقييم:
يتم تقييم وضع الأنف لدى استشاري الأنف والأذن والحنجرة في العيادة. ويفضل اجراء التنظير الأنفي للكشف عن الجيوب الأنفية والجزء الخلفي من الأنف بالاضافة الى البلعوم الأنفي. والهدف من التنظير هو الكشف عما اذا كانت هنالك مضاعفات لانحراف الحاجز أم لا.
العلاج:
العلاج الوحيد لانحراف الحاجز الأنفي هو العملية، لكن متى يتوجب اجراء العملية؟ لا يحتاج كل انسان لديه انحراف الى تعديله، حيث ان أغلب البشر لديهم هذا الانحراف. يتم تعديل الحاجز الأنفي في الحالات التالية:
1- صعوبة التنفس أو انسداد الأنف بسبب انحراف الحاجز.
2- تشوه منظر الأنف وانحرافه الخارجي بسبب الحاجز.
3- حدوث مضاعفات بسبب الانحراف كالتهاب الجيوب الأنفية والصداع المزمن والشخير والنزيف الأنفي والتهاب الاذن المتكرر وغيرها.
العملية:
يتم تعديل الحاجز الأنفي بعملية من داخل الأنف ويمكن أن تجرى تحت التخدير الموضعي أو التخدير العام. توضع حشوة أنفية صغيرة في الأنف وتتم ازالتها خلال 24 ساعة ويغادر المريض ويستطيع العودة الى عمله خلال يومين. نسبة نجاح العملية عالية جدا وتعطي شعورا لدى المريض بفرق كبير في التنفس مقارنة بما قبل العملية.

 في السودان نجد أن المدونات الفولكلورية قد مرت بمراحل عديدة حتي وصلت إلي المرحلة العلمية، ومن أميز هذه المراحل: - مرحلة المؤرخين العرب - مرحلة الممالك الإسلامية - مرحلة المؤرخين المصريين - فترة الإستعمار وأخيراً مرحلة ما بعد الإستقلال وحتي إفتتاح معهد أبحاث السودان 1964، والذي صار فيما بعد 1972 معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، الذي يؤرخ لظهور الدراسات العلمية للفولكلور، وأما الفترات السابقة فقد كانت الكتابات فيها وصفية ترتكز علي الإهتمامات الشخصية للكاتب، إلي جانب بعض الدراسات التي قام بإعدادها دارسين وباحثين إنثربولوجيين ودارسي علم إجتماع وغيرهم. وأما دور المؤرخين العرب فقد كان الهدف الأساسي من رحلاتهم هو التعرف علي الشعوب وغرائبهم، وليس لدراسة الفولكلور، ومن هؤلاء: المسعودي - القلقشندي - الطبري، ومنهم أيضاً ابن التونسي الذي ألف كتاب تشحيذ الأذهان الذي ركز فيه علي العادات والتقاليد الإجتماعية والثقافية والمادية مصحوبة برسومات توضيحية، ومن رحالة القرن التاسع عشر الطهطاوي الذي دون ملاحظات عن السودان في كتابه مناهج الألباب.
في السودان نجد أن المدونات الفولكلورية قد مرت بمراحل عديدة حتي وصلت إلي المرحلة العلمية، ومن أميز هذه المراحل: - مرحلة المؤرخين العرب - مرحلة الممالك الإسلامية - مرحلة المؤرخين المصريين - فترة الإستعمار وأخيراً مرحلة ما بعد الإستقلال وحتي إفتتاح معهد أبحاث السودان 1964، والذي صار فيما بعد 1972 معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، الذي يؤرخ لظهور الدراسات العلمية للفولكلور، وأما الفترات السابقة فقد كانت الكتابات فيها وصفية ترتكز علي الإهتمامات الشخصية للكاتب، إلي جانب بعض الدراسات التي قام بإعدادها دارسين وباحثين إنثربولوجيين ودارسي علم إجتماع وغيرهم. وأما دور المؤرخين العرب فقد كان الهدف الأساسي من رحلاتهم هو التعرف علي الشعوب وغرائبهم، وليس لدراسة الفولكلور، ومن هؤلاء: المسعودي - القلقشندي - الطبري، ومنهم أيضاً ابن التونسي الذي ألف كتاب تشحيذ الأذهان الذي ركز فيه علي العادات والتقاليد الإجتماعية والثقافية والمادية مصحوبة برسومات توضيحية، ومن رحالة القرن التاسع عشر الطهطاوي الذي دون ملاحظات عن السودان في كتابه مناهج الألباب. ثم تأتي فترة الفتح الإنجليزي التي فيها نعوم شقير الذي ينفذ المنهج الإنثربولوجي لتنفيذ السياسات الإستعمارية بشكل أقرب للفولكلور، فأهتموا بصميم المادة الفولكلورية، وركزوا علي جنوب السودان ودارفور. ويلي ذلك ظهور (مجلة السودان في رسائل ومدونات) 1918التي من كتابها عبدالله الطيب: "العادات المتغيرة للمجموعات النيلية"، وايفانز بريتشارد: "الزاندي"، وبقية المجلات السودانية: النهضة - الفجر - حضارة السودان - الرائد. ثم ثمرة خريجي كلية غوردون مثل الشيخ أحمد عثمان القاضي وعبدالله عبدالرحمن الضرير(العربية في السودان)، ثم دور الرواة مثل الشيخ بابكر بدري (كتاب الأمثال)، وإبراهيم العبادي، ثم عبدالله الطيب (الأحاجي السودانية).
ثم تأتي فترة الفتح الإنجليزي التي فيها نعوم شقير الذي ينفذ المنهج الإنثربولوجي لتنفيذ السياسات الإستعمارية بشكل أقرب للفولكلور، فأهتموا بصميم المادة الفولكلورية، وركزوا علي جنوب السودان ودارفور. ويلي ذلك ظهور (مجلة السودان في رسائل ومدونات) 1918التي من كتابها عبدالله الطيب: "العادات المتغيرة للمجموعات النيلية"، وايفانز بريتشارد: "الزاندي"، وبقية المجلات السودانية: النهضة - الفجر - حضارة السودان - الرائد. ثم ثمرة خريجي كلية غوردون مثل الشيخ أحمد عثمان القاضي وعبدالله عبدالرحمن الضرير(العربية في السودان)، ثم دور الرواة مثل الشيخ بابكر بدري (كتاب الأمثال)، وإبراهيم العبادي، ثم عبدالله الطيب (الأحاجي السودانية).